بِِصٌمَةّ خَيِّر
19 Apr 2023 07:18
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 28 )
#الامام_البركوي
هو محمد بن بير علي بن إسكندر الرومي البِرْكِويّ نسبة إلى برْكَي
كان يلقب بعدة ألقاب وهي: تقيّ الدين، ومحيي الدين، وزين الدين.
ولد البركوي رحمه الله في مدينة بألِيكَسْرْ الواقعة في الشمال الغربي من تركيا، سنة 929هـ وبها نشأ وترعرع.
طلب العلم منذ صغره على والده الذي كان عالمًا من علماء الدولة العثمانية في ذلك الوقت، وكان مدرسًا في مدينة أليكسر، فحفظ القرآن في صغره. وعندما أدرك الأب العالم نباغة الابن وحبه للعلم؛ أرسله إلى اسطنبول.
ثم التحق البركوي بالمدارس التي أنشأها السلطان محمد الفاتح في اسطنبول وكانت هذه المدارس بمثابة الجامعات من حيث الدراسة وطريقة تدريس العلوم فيها فكان طلاب العلم يفدون إليها من جميع أنحاء تركيا طلبا للعلم الشرعي.
برع البركوي في علوم متعددة، فبرز في الفقه والتفسير والحديث والعقيدة والفرائض والتجويد والنحو والصرف، بل إنه كان عالما بالبيان والحساب، حتى أصبح علامة عصره .
بعد إتمام البركوي دراسته في اسطنبول عين مدرسًا بها، ثم انتقل منها إلى مدينة أدرنة عاصمة تركيا السابقة، وعين فيها مشرفا على توزيع تركة الموتى من الجند على ورثتهم، وهذا لنبوغه في الفرائض والحساب، كان يطلق على هذه الوظيفة (القسَّام العسكري)
ثم عينه عطاء الله أحمد أفندي مدرسًا في مدرسته التي بناها في مسقط رأسه بركي، وكان إلى جانب ذلك يلقي الدروس في المدارس والمساجد.
كان المذهب الحنفي هو السائد في الدولة العثمانية.
وقد برز ميوله الحنفي في بعض رسائله المتعلقة بالفقه إلا إن البركوي كان نابذًا للتقليد والتعصب المذهبي، وكان يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة، فيقول : (وقد رزقني الله والحمد لله من العلوم العربية، والعقلية، والمعارف الدينية الشرعية الشريفة ما أميز به بين الصحيح والسقيم، والقوي والضعيف، والخطأ والصواب، وانحل عن قلبي عقدة التقليد بعض الانحلال، وامتزج تحقيقي بالتحقيق والإتقان).
ويذكر أن البركوي كان العالم الوحيد الذي لقب بالإمام من بين علماء الأتراك في زمانه.
وقد عد الإمام البركوي من مجددي الإسلام في القرن العاشر الهجري في البلاد التركية؛ إذ كان مجاهدًا للبدع والخرافات ورادًّا على أهلها ومبينًا زيفهم وباطلهم، حتى اعتبره بعض العلماء امتدادًا لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
*أبرز شيوخه*:
والده بير علي البركوي.
المولى شمس الدين أحمد
المولى عبد الرحمن بن علي الأماسي
أخي زاده قرماني محمد
المتأمل في كتاباته يجد أنه كان شديد العناية بالكتاب والسنة، متبعًا للأثر وأقوال السلف الصالح فيما يخص المسائل العقدية، وكان ذا غيرة على الدين؛ حيث رد على كثير من الفرق المبتدعة، واجتهد في بيان باطلها، ومن ثم نقدها وإقامة الحجج والبراهين.
قال عنه صاحب كتاب (العقد المنظوم) : آية في الزهد والصيانة، ونهاية في الورع والديانة، رأسا في التجنب والتقوى، متمسكا بما هو أتم وأقوى)
وكان قائمًا على الحق في كل مكان، يرد على من يخالف الشريعة كائنا من كان، لا يهاب أحدًا.
أثنى عليه صاحب العقد المنظوم علي بن بالي، فقال عنه: (ممن تعانى العلم والعمل، وحصل وكمل، فالتحق في شبابه بالمشايخ الكمل …، وكان في طرف عال من الفضل والكمال، وتتبع الكتب والرسائل، وجمع القواعد والمسائل، وجمع العلم وتبحر فيه، وحوى من الفضل والمعرفة ما يكفيه)
وامتدحه العلامة داود القارصي بقوله: (الإمام العلامة، والفاضل الكرامة، وحيد عصره في التحقيق، وفريد دهره في التدقيق محمد أفندي البركوي.
وممن أثنى عليه العلامة ابن عابدين، فقال عنه: (أفضل المتأخرين الإمام العالم العامل، المحقق المدقق الكامل، الشيخ محمد البركوي وقال عنه أيضًا: الإمام العابد الورع النبيه.
ويصفه الشيخ محمد بن جمعة المقار الحنفي: بالشيخ الإمام، والمولى الهمام، العالم العامل، الفاضل الكامل محمد أفندي البركلي الرومي.
وقال الزركلي عنه: عالمٌ بالعربية نحوًا وصرفًا له اشتغال بالفرائض ومعرفة بالتجـويد
*للعلامة البركوي عدد كبير من المصنفات وهذه قائمة بأسماء بعض مصنفاته* :
آداب البركوي
الأربعون في الحديث
إظهار الأسرار في النحو
إيقاظ النائمين وإفهام القاصرين
تحفة المسترشدين في بيان مذاهب فرق المسلمين
جلاء القلوب
دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين في الكلام
الدر اليتيم في علم التجويد
ذخر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء
السيف الصارم في عدم جواز وقف النقود والدراهم
رسالة البركلي وهي رسالة كتبها بالتركية فعم النفع بها بين العوام
الطريقة المحمدية وهي في الموعظة
زيارة القبور البدعية والشركية
اتفقت المصادر التي ترجمت له على أنه توفي سنة 981*هـ.
مركز سلف للبحوث والدراسات
✍ تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
17 Apr 2023 09:35
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 26 )
#عبد_الباقي_الزرقاني
هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد شهاب الدين بن محمد بن علوان، الشهير بالزُّرقاني المصري الأزهري المالكي، أبو عبد الله.
نشأ محمد بن عبد الباقي الزرقاني في جو علمي ابتداء من أسرته التي كانت أسرة علم، اشتهرت بذلك في الديار المصرية، عرفوا بالتأليف والتدريس ونشر أحكام الدين وأصوله. كان محمد بن عبد الباقي الزرقاني شغوفا بالعلم والعلماء منذ صغر سنه، حفظ القرآن الكريم ثم تعلم مبادئ اللغة والعبادة ثم انتقل إلى حلقات العلماء بالجامع الأزهر حيث المتون والشروح والأمهات في كل المجالات تدرس من طرف فطاحل العلماء.
وَكَانَ عَالما نبيلاً فَقِيها متبحراً لطيف الْعبارَة ولد بِمصْر فِي سنة عشْرين وَألف وَبهَا نَشأ وَلزِمَ النُّور الأَجْهُورِيّ سِنِين عديدة وَشهد لَهُ بِالْفَضْلِ وَأخذ عُلُوم الْعَرَبيَّة عَن الْعَلامَة يس الْحِمصِي والنور الشبراملسي وَحضر الشَّمْس البابلي فِي دروسه الحَدِيث وَأَجَازَهُ جلّ شُيُوخه وتصدر للإقراء بِجَامِع الْأَزْهَر وَألف مؤلفات كَثِيرَة مِنْهَا شرح على مُخْتَصر خَلِيل تشد إِلَيْهِ الرّحال وَشرح على العزية وَغير ذَلِك وَكَانَ رَقِيق الطَّبْع حسن الْخلق جميل المحاورة لطيف التأدية للْكَلَام وَكَانَت وَفَاته ضحى يَوْم الْخَمِيس رَابِع عشري شهر رَمَضَان سنة تسع وَتِسْعين وَألف بِمصْر وَدفن بتربة المجورين.
مؤلفاته:
من مؤلفاته شرح موطأ الإمام مالك في كتاب سماه "أبهج المسالك بشرح موطأ الإمام مالك"، وهو شرح وسط بين الطول والقصر، وتعرض فيه لشرح متون الأحاديث من جهة اللغة، وأفاض في شرح المذاهب الفقهية، ولم يعن بالرجال ولا بتراجم الأبواب، وقد نال الكتاب حظا موفورًا من الشهرة.
قال عنه محمد علوي المالكي: «فلا أظنّ أنّني مجانبٌ للواقعِ الصّادقِِ إن قلت: إنّ هذا الشّرح أحسن شروح الموطأ المتوسّطة، مفيدٌ لمن اقتصر عليه، وجيّدٌ لمن رجع إليه.»
وله إشراق مصابيح السير المحمدية بمزج أسرار المواهب اللدنية: (شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني).
قال سركيس: وهو شرح حافل جمع فيه أكثر الأحاديث المروية في شمائل المصطفى وسيره وصفاته الشريفة.
وله شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث.
وله مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة.
موقع مـداد
✍ تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
15 Apr 2023 11:11
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 24 )
#الإمام_القعنبي
عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، أحد علماء السنة والجماعة ومن كبار رواة الحديث، تتلمذ على يد الإمام مالك ونهل من فيض علمه، عاش حياة اللهو والترف في بداية حياته إلا أن الله فتح على قلبه وبصيرته فهداه على يد الإمام المحدث شعبة بن الحجاج، وأصبح من أكبر رواة الحديث ومن تلامذته الإمام البخاري، ومسلم وأبو داوود، الذين نهلوا من علمه حتى توفى في مكة في عام 221هـ.
عاش القعنبي حياة اللهو مع أصدقاء السوء فكان لا يتورع عن شرب الخمر في الطرق بين الناس، فلا يخشى ولا يخاف أحد، حتى شاء الله تعالى أن يشرح قلبه للهداية وينير بصيرته بالعلم من خلال لقائه مع الإمام الشعبي الذي تعامل مع القعنبي بذكاء العلماء، حتى تغيرت حياة القعنبي بين يوم وليلة وصار يطلب العلم في كل مكان وتتلمذ على يد الإمام مالك حتى نهل من فيض علمه وارتوى به.
يروى العلماء أن القعنبي كان في احد الأيام يجلس على قارعة الطريق يعاقر الخمر كعادته، ولا يناله من الحياء شيء، فوجد زحمة وجمع من الناس يلتفون حول رجل يركب حماره، فلفت انتباه القعنبي المنظر وقرر الوصول لهذا الرجل الذي يحتفي به الناس، وبالفعل اخترق جموع الناس حتى وصل إلى راكب الحمار، ومسك لجام الحمار قائلاً لراكبه، من أنت ؟، قال الراكب : شعبة، رد القعنبي : ومن شعبة ؟، وقع السؤال كالصاعقة على جميع الموجودين (فهل يوجد في البصرة من لا يعرف شعبة ابن الحجاج، أحد محدثي الأمة وراوي الأحاديث)، فرد عليه تلامذة شعبة قائلين : محدث، قال القعنبي : وما محدث ؟ ما شغله؟، (فقد كان بعيداً كل البعد عن حياة المسلمين)،أعاد القعنبي السؤال : ماذا يفعل المحدث ؟، قالوا : محدث، (فهم لا يصدقون أنه يوجد بين المسلمين من لا يعلم من هو المحدث)، قال : وما محدث يبيع ماذا ؟، قالوا : محدث يروي أحاديث.
وجه القعنبي الحديث مستهزًأً لشعبة قائلًا : حدثني بحديث مما تعرف، في هذه اللحظة علم شعبة أنه أمام أحد الشباب الذين لا يعلمون شيئًا عن دينهم لذلك قرر أن يجيبه بإجابة تصبح درسًا له طوال حياته، قال شعبة : حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : “إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستح فاصنع ما شئت”، فوقعت الكلمات في قلب القعنبي قبل أذنه حتى أنه ترك اللجام من يده، وظل يبكي حتى عاد لبيته، فوجد أمه فقال لها : إذا عاد أصحابي أخبريهم بأني سكبت الشراب، فإذا علموا رحلوا عني.
ظل يبحث القعنبي عن أعلم أهل الحديث، فدله الناس على الإمام مالك فذهب إلى المدينة وتعلم على يده وكان من أنجب تلاميذه حتى يروى أن الإمام مالك قرأ نصف الموطأ على القعنبي، والقعنبي قرأ النصف الآخر على الإمام مالك، أصبح القعنبي من محدثي الحديث وأحد علماء ورواة الأحاديث الثقة، تتلمذ على يده الإمام البخاري، و الإمام مسلم ، وأبو داوود، وتوفى في عام 221 هـ، بمكة المكرمة.
المرسال
الكاتب / ايمان سامي
المراجع: كتاب التوابين لابن قدامة رحمه الله
✍ أسعد الله أوقاتكم بطاعته
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
13 Apr 2023 11:06
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 22 )
#الحافظ_المنذري
هو الحافظ الكبير أبو محمد عبد العظيم زكي الدين بن عبد القوي المنذري، الشامي ثم المصري، الشافعي، صاحب التصانيف النافعة المفيدة.
ولد في غرَّة شعبان من سنة إحدى وثمانين وخمسمائة، وقرأ القرآن الكريم على أبي عبد الله الأَرْتاحِي، وتفقه على أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد القرشي، وتأدب على أبي الحسين بن يحيى النحوي، وسمع من عبد المجيب بن زهير ومحمد بن سعيد المأموني والمطهر بن أبي بكر البيهقي، وغير هؤلاء من أفاضل علماء عصره، وارتحل لسماع الحديث إلى مكة ودمشق وحرَّان والرها والإسكندرية، ولزم الحسن على بن المفضل مدة.
تخرَّج عليه قوم صاروا بعدُ من أساطين العلماء، وذاع صيتهم، ونَبُه ذكرهم: منهم الحافظ أبو محمد الدمياطي، وأبو الحسين اليونيني، وإسماعيل بن عساكر، وعلم الدين الدواداری، وتقي الدين ابن دقيق العيد، وغير هؤلاء.
درَّس بالجامعِ الظَّافري بالقاهرة مدَّةً، ثم وَلِي دار الحديث الكاملية، وانقطع بها نحو عشرين سنة.
قال ابن ناصر الدين: «كان حافظًا كبيرًا، حجةً، ثقةً، عُمدةً».
وقال الشريف عزُّ الدِّينِ: «كان عديمَ النَّظير في معرفةِ علومِ الحديثِ على اختلاف فنونِه، عالمًا بصحيحه وسقيمه، ومعلوله وطرُقِه، متبحِّرًا في معرفةِ أحكامِه ومعانيه ومشكله، قيِّمًا بمعرفةِ غريبهِ، وإعرابه واختلاف ألفاظِه، ماهرًا في معرفة رُوَاته وجَرْحِهم وتعديلهم، ووفياتهم ومواليدهم، وأخبارهم، إمامًا، حُجَّة، ثَبَتًا، وَرِعًا، متحرِّيًا فيما يقولُه، متثبِّتًا فيما يرويه.
وقال الذهبي: «لم يكن في زمانِه أحفظَ منه».
صنَّف قبلَه في التَّرغيبِ والتَّرهيبِ قومٌ: منهم أبو مُوسى المدِينيُّ، وابن زَنْجُويَه حُميد بُن مَخلدٍ بن قتيبة الأزدي، والشيخ الإمامُ قوَّامُ السُّنَّةِ أبو القاسمِ إسماعيل بنُ محمدٍ الأصبهاني المتوفي في سنة خمس وثلاثين وخمس مئة. وقد نصَّ الحافظ المنذريُّ على أنه اطلع على كتاب الأصبهاني ونقل عنه، قال: «واستوعبت جميع ما في كتاب أبي القاسم الأصبهاني ما لم يكن في الكتب المذكورة، وهو قليل، وأضربت عن ذكر ما فيه من الأحاديث المتحققة الوضع»، وقد أخمل كتاب المنذري غيره من الكتب التي وضعت من قبله في موضوع كتابه، ببركة ورعه وتقواه، وبواسع معرفته وتحرِّيه الدقة، ثم بحسن اختياره وتبويبه، فلم يعد أهل العلم يعرفون من كتب الترغيب والترهيب من الحديث النبوي غير كتاب الحافظ المنذري، وصار هو وحده مراجع الطالبين، ومحط رحال الواعظين.
وللحافظ المنذري - غير كتاب «الترغيب والترهيب» هذا - كتبٌ كلُّها يدلُّ على واسع الحفظ ودقة التَّحرِّي، وعلى شديد الورع منها.
*مختصر صحيح الإمام مسلم بن الحجاج*، وقد شاركه في هذا العمل معاصره أبو الفضل محمد بن عبد الله المريسي ، ولكن العلماء عُنوا بمختصر الحافظ المنذري وتلقوه بالقبول ثم قاموا بشرحه، وممن شرحه العلامة عثمان بن عبد الملك الكردي المصري ومنهم العلامة محمد بن أحمد الأسنوى .
*مختصر سنن أبي داود الذي سماه المجتبى*، وقد شرحه الحافظ جلال الدين السيوطي شرحًا وسطًا وسماه «زهر الرُّبى على المجتبى» وهذَّبه الإمام محمد ابن أبي بكر، المعروف بابن قيم الجوزية.
وتوفي في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة من سنة ست وخمسين وستمائة، رحمه الله تعالى ورضي عنه.
وتجد للحافظ المنذري ترجمة في المراجع الآتية:
شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي
فوات الوفيات لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي
تاريخ الحافظ ابن كثير المسمى البداية والنهاية
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي
تاريخ ابن الوردي
المصدر: مقدمة تحقيق «الترغيب والترهيب» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد
الألوكة
✍ أسعد الله أوقاتكم بطاعته
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
11 Apr 2023 12:02
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 20 )
#ايوب_السختياني
هو الإِمَامُ, الحَافِظُ سَيِّدُ العُلَمَاءِ, أبي بَكْرٍ بن أبي تميمة كيسان العنزي مَوْلاَهُم, البَصْرِيُّ, الآدَمِيُّ وَيُقَالُ: وَلاَؤُهُ لِطَهِيِّةَ. وَقِيْلَ: لِجُهَيْنَةَ. عِدَادُه فِي صِغَارِ التَّابعِيْنَ.
سَمِعَ مِنْ أَبِي بُرَيْدٍ الجَرْمِيِّ, وَأَبِي عثمان النهدي, وسعيد بن جُبَيْرٍ, وَالحَسَنِ البَصْرِيِّ, وَمُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ, وَعَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ, وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ, وقتادة, وخلق سواهم.
حَدَّثَ عَنْهُ: مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ, وَعَمْرُو بنُ دِيْنَارٍ, وَالزُّهْرِيُّ, وَقَتَادَةُ -وَهُم مِنْ شُيُوْخِهِ- وَيَحْيَى بن أبي كَثِيْرٍ, وَمَالِكٌ, وَسُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ, وَأُمَمٌ سِوَاهُم.
مَوْلِدُه عَامَ تُوُفِّيَ ابْنُ عَبَّاسٍ, سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّيْنَ.
حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ, قَالَ: لَقِيَ ابْن عُيَيْنَةَ سِتَّةً وَثَمَانِيْنَ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَكَانَ يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَيُّوْبَ.
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُوْلُ: كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَيُّوْبَ السِّخْتِيَانِيِّ, فَإِذَا ذَكرْنَا لَهُ حَدِيْثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى حَتَّى نَرحَمَه.
كَانَ أَيُّوْبُ السِّخْتِيَانِيُّ يَقُوْمُ اللَّيلَ كُلَّه فَيُخفِي ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ رَفعَ صَوْتَه كَأَنَّهُ قَامَ تِلْكَ السَّاعَةَ.
حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بنُ مِسْكِيْنٍ: سَمِعْتُ أَيُّوْبَ يَقُوْلُ: لاَ خَبِيْثَ أخبث من قارىء فاجر.
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوْبَ, قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ هَا هُنَا, وَكَلاَمُهُم: إِنْ قُضِيَ وَإِنْ قُدِّرَ. وَكَانَ يَقُوْلُ: لِيتَّقِ اللهَ رَجُلٌ فَإِنْ زَهِدَ فَلاَ يَجْعَلَنَّ زُهْدَه عَذَاباً عَلَى النَّاسِ, فَلأَنْ يُخْفِيَ الرَّجُلُ زُهْدَه خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُعْلِنَه.
وَكَانَ أَيُّوْبُ مِمَّنْ يُخفِي زُهْدَه دَخَلنَا عَلَيْهِ, فَإِذَا هُوَ عَلَى فِرَاشٍ مُخَمَّسٍ أَحْمَرَ, فَرَفَعتُه- أَوْ رَفَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- فَإِذَا خَصَفَةٌ مَحْشُوَّةٌ بِلِيْفٍ.
قَالَ مَخْلَدُ بنُ الحُسَيْنِ قَالَ أَيُّوْبُ مَا صَدَقَ عَبْدٌ قَطُّ فَأَحَبَّ الشُّهرَةَ.
وَقَالَ يُوْنُسُ بنُ عُبَيْدٍ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَنصَحَ لِلْعَامَّةِ مِنْ أَيُّوْبَ وَالحَسَنِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ الكَاتِبُ: كَانَ أَيُّوْبُ ثِقَةً ثَبْتاً فِي الحَدِيْثِ جَامِعاً كَثِيْرَ العِلْمِ حُجَّةً عَدلاً.
وَقَالَ أبي حَاتِمٍ, وَسُئِلَ، عَنْ أَيُّوْبَ فَقَالَ: ثِقَةٌ لاَ يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ.
قُلْتُ: إِلَيْهِ المُنْتَهَى فِي الإِتْقَانِ.
قَالَ ابْنُ المَدِيْنِيِّ: لَهُ نَحْوٌ مِنْ ثَمَانِ مائَةِ حَدِيْثٍ وَأَمَّا ابْنُ عُلَيَّةَ فَقَالَ: كُنَّا نَقُوْلُ: حَدِيْثُ أَيُّوْبَ أَلْفَا حَدِيْثٍ فَمَا أَقَلَّ مَا ذَهَبَ عَلَيَّ مِنْهَا.
رَوَى ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ قَالَ: كَانَ أَيُّوْبُ يَؤُمُّ أَهْلَ مَسْجِدِه فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَيُصَلِّي بِهِم فِي الرَّكعَةِ قَدرَ ثَلاَثِيْنَ آيَةً, وَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ فِيْمَا بَيْنَ التَّروِيْحَتَيْنِ بِقَدرِ ثَلاَثِيْنَ آيَةً, وَكَانَ يَقُوْلُ هُوَ بِنَفْسِهِ لِلنَّاسِ الصَّلاَةَ وَيُوْتِرُ بِهِم وَيَدعُو بِدُعَاءِ القُرْآنِ, وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ, وَآخِرُ ذَلِكَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُوْلُ اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِه وَأَوْزِعْنَا بِهَدْيِه وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَاماً ثُمَّ يَسْجُدُ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ دَعَا بِدَعَوَاتٍ.
قَالَ سَعِيْدُ بنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ، عَنْ سَلاَّمِ بنِ أَبِي مُطِيْعٍ, قَالَ: رَأَى أَيُّوْبُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ, فَقَالَ: إِنِّي لأَعرِفُ الذِّلَّةَ فِي وَجْهِه, ثُمَّ تَلاَ {سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّة} [الأَعْرَافُ: 152] ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ لِكُلِّ مُفتَرٍ وَكَانَ يُسَمِّي أَصْحَابَ الأَهْوَاءِ: خَوَارِجَ وَيَقُوْلُ: إِنَّ الخَوَارِجَ اخْتَلَفُوا فِي الاسْمِ وَاجْتَمَعُوا عَلَى السَّيفِ.
قَالَ صَالِحُ بنُ أبي الأخضر: قلت لأيوب: أوصيني قَالَ: أَقِلَّ الكَلاَمَ.
قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ أَيُّوْبُ: ذُكِرْتُ, وَلاَ أُحِبُّ أَنْ أُذْكَرَ.
قُلْتُ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاَثِيْنَ وَمائَةٍ بِالبَصْرَةِ, زَمَنَ الطَّاعُوْنِ, وَلَهُ ثَلاَثٌ وَسِتُّوْنَ سَنَةً.
سير أعلام النبلاء الذهبي
موقع تراجم عبر التاريخ
✍ أسعد الله أوقاتكم بطاعته
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
09 Apr 2023 11:30
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 18 )
#محمد_بن_فطيس_الغافقي
الولادة 229 هـ
الوفاة إلبيرة-الأندلس عام 319 هـ
مُحَمَّد بن فُطَيس بن وَاصِل الغَافِقِيّ: من أهل إلبيرَة؛ يُكَنَّى: أبا عَبْد الله.
مُحدث الأندلس وأحد كبار علماء المالكية فيها، وأحد رواة الحديث النبوي.
رَوَى بالأندلُس، عن مُحَمَّد بن أحمد العُتْبِيّ، وأبَان بن عيسى بن دِينار، ويحيى بن إبراهيم آبن مُزْيَن، وغيرهم.
ورحل إلى المَشْرق سنة سبع وخمسين ومائتين وتَرَدّد هناك. فسمع بمصر: من يونس بن عبد الأعلى، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن عبد الحكم وغيرهم.
وسَمِع بمكة: من أبي بكر عَبْد الله بن حمزة القرشيّ، ومُحَمَّد بن إسحاق السَّجستي، وغيرهم.
وسمع بطْرَابُلس: من أحمد بن عَبْد الله بن صالح الكُوفيّ، وبإفْريقيَّة من شخوة بن عيسى القاضي وجماعة سواهم من أئمة الحديث، وأعلام الرواية.
وأكثر في طلب العلم والسماع عن أهل الحرم ، ومصر ، والقيروان ، وتفقه بالمزني ، وأدخل الأندلس علما غزيرا .
وكان بصيرا بفقه مالك ، وكان يقول : لقيت في رحلتي مائتي شيخ ما رأيت فيهم مثل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم .
قال ابن الفرضي وغيره : صارت إليه الرحلة من البلاد ، وعمر دهرا .
وصنف كتاب " الروع والأهوال " ، وكتاب " الدعاء " . وكان ضابطا نبيلا صدوقا .
وكان مُحَمَّد بن فُطَيْس نبيلاً، ضابطاً لكتبه، ثقة في روايته، صَدُوقاً في حديثه. وكانت الرحلة إليه بإلبيرَة، وإلى أحمد بن منصور. ثمَّ مَاتَ أحمد بن منصور فانصرف بعلو الدرجة، ورياسة الاسناد.
وكان: يُقْصَد إليه للسماع منه بِقُرْطُبَة وغيرها. وقد حَدَّثنا عنه غير واحد.
وتُوفِّي مُحَمَّد بن فُطَيْس (رحمه الله) : بحاضرة إلبيرَة في شوّال سنة تسع عشرة وثلاث مائة. أخبرني بذلك أبو مُحَمَّد الباجيّ، وسَهل بن إبراهيم وغير واحد من أهل إلبيرة. وقال لي سهل: تُوفِّي وهو آبن تسعين سنة.
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي
سير أعلام النبلاء
اسلام ويب/ تراجم عبر التاريخ
✍ أسعد الله أوقاتكم بطاعته
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
07 Apr 2023 14:03
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 16 )
#بدر_الدين_العيني
ولد محمود بن أحمد بن موسى المعروف ببدر الدين العيني في قاعة عينتاب بالقرب من حلب (26 من رمضان 762هـ 1361م)، ونشأ في بيت علم ودين، وتعهده أبوه وكان قاضيًا بالرعاية والتعليم، فحفظ القرآن، وتعلم القراءة والكتابة، وتعلم القراءات السبع ، ودرس الفقه الحنفي على يد والده وغيره من الشيوخ، و رحل إلى حلب والي دمشق بعد وفاة والده طلبًا للمزيد من العلم.
في أثناء إقامته بمكة والمدينة التقى بعلمائها وأخذ العلم عنهم، ثم عاد إلى وطنه، وجلس للتدريس، وظل عامين يؤدي رسالته، ثم رغب في زيارة بيت المقدس ، والتقي العيني هناك بالشيخ علاء الدين السيرامي ملك العلماء في عصره، فلازمه وتتلمذ على يديه، وقدم معه إلى القاهرة.
ولما قدم “السيرامي” القاهرة ولاه السلطان الظاهر برقوق مشيخة مدرسته الكبرى التي أنشأها، واحتفى به وأكرم وفادته، وألحق السيرامي تلميذه النابه بالمدرسة مساعدًا له، وانتهز العيني فرصة وجوده بالقاهرة، فجد في تلقي الحديث عن شيوخه الأعلام، فسمع كتب السنة ومسند أحمد وسنن الدارقطني، والدارمي، ومصابيح السنة للبغوي، والسنن الكبرى للنسائي على يد سراج الدين البلقيني، وغيرهم، حتى إذا توفي شيخه السيرامي حل بدر الدين العيني محل شيخه في التدريس بالمدرسة الظاهرية، عزل بعدها من المدرسة بسبب بعض الوشايات المغرضة.
ومن ثم تقلب في وظائف عديدة، فتقلد ولاية الحسبة لأول مرة خلفًا للمقريزي، وقد قام في أثناء توليه هذا المنصب بالالتزام بتطبيق الشريعة، وضبط الأسواق وتوفير السلع، والضرب على يد المحتكرين، وكان يلجأ إليه السلاطين لمباشرة هذه الوظيفة حين تضطرب أحوال السوق، وتشح البضائع، وترتفع الأسعار، لما يعلمون من نزاهته وكفاءته.
وتولى منصب ناظر الأحباس، وهو يشبه وزير الأوقاف في عصرنا الحديث ، لمدة أربعا وثلاثين سنة دون انقطاع ، كما تولى منصب قاضي قضاة الحنفية في عهد السلطان برسباي.
ولم ينقطع عن التدريس، وتتلمذ على يديه عدد من التلاميذ النابهين صاروا أعلامًا بعد ذلك، مثل: الكمال بن الهمام الفقيه الحنفي الكبير، وابن تغري بردي، والسخاوي، وأبي الفضل العسقلاني.
وسجل التاريخ تنافسًا محتدمًا اشتعل بينه وبين ابن حجر العسقلاني؛ فكلاهما إمام وفقيه ومؤرخ، انتهت إليهما زعامة مذهبهما؛ فابن حجر شافعي المذهب والعيني حنفي المذهب، وتقلد كل منهما القضاء، ولكل منهما أنصار وأعوان، وأنهما عمدا إلى صحيح البخاري فوضعا له شرحًا وافيًا، وكان ذلك سببًا في ذروة الخلاف بينهما.
على أن روح التنافس بينهما لم تمنع أحدهما من الاستفادة من الآخر، فقد تلقى ابن حجر عن العيني حديثين من صحيح مسلم وآخر من مسند أحمد، وترجم له ضمن شيوخه في كتابيه: المجمع المؤسس في المعجم المفهرس، ورفع الأصر عن قضاة مصر، وذكر السخاوي في كتابه “الضوء اللامع” أنه رأى العيني يسأل ابن حجر في مرض موته، وقد جاء ليعوده عن مسموعات الزين العراقي.
عاصر بدر الدين العيني كثيرًا من سلاطين مصر، فولاه “المؤيد شيخ” التدريس في مدرسته المؤيدية، وأرسله مبعوثًا عنه إلى بلاد الروم وكان يدخل عليه مجلس حكمه في أي وقت، وازدادت علاقته توثقًا بالسلطان برسباي، وقامت بينهما علاقة حميمة، وساعدت إجادة العيني للتركية في زيادة عرى المودة بينهما؛ لأن السلطان كان ضعيف العربية لا يحسن الحديث بها، وقام العيني بتثقيف السلطان وتعليمه كثيرًا من أمور الدين، وقراءة فصول من كتبه التاريخية له بعد ترجمتها للتركية.
وعكف علي مواصلة الدرس والتأليف، فوضع مؤلفات كثيرة وفي موضوعات مختلفة في الفقه والحديث والتاريخ والعربية ومن أشهر مؤلفاته:
– عمدة القاري في شرح الجامع الصحيح للبخاري، وهو من أجل شروح البخاري، استغرق العيني في تأليفه مدة تزيد عن عشرين عامًا
– البناية في شرح الهداية وهو في فقه الحنفية
– رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق، وهو في فقه الحنفية
– عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، وهو كتاب ضخم، تناول فيه الأحداث التاريخية منذ أول الخلق حتى سنة (850هـ= 1447م)
أقام العيني مدرسة لنفسه قريبًا من الجامع الأزهر سنة (814هـ= 1411م)، كانت قريبة من سكنه، يؤمها طلابه الذين يقصدونه لتلقي الفقه والحديث على يديه، وأوقف عليها كتبه لطلبة العلم، وبعد ثلاث وتسعين سنة قضى معظمها العيني ملازمًا التصنيف والتدريس لقـي الله في (4 من ذي الحجة 855هـ= 28 من ديسمبر 1451م)، ودفن بمدرسته التي صارت الآن مسجدًا.
وجدير بالذكر أن مستشفى قصر العيني بالقاهرة تنسب إلى حفيده شهاب الدين أحمد بن عبد الرحيم بن محمود العيني، أحد الأمراء المعروفين.
أحمد تمام – باحث مصري في التاريخ والتراث.
إسلام أون لاين
✍ أسعد الله أوقاتكم بطاعته
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
05 Apr 2023 12:46
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 14 )
#ابو بكر_الاثرم
هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي، الإسكافي، أبو بكر الأثرم: من حفاظ الحديث.
ولد في دولة الرشيد.
وسمع من: عبد الله بن بكر السهمي، ومن هَوْذَة بن خليفة، وأحمد بن إسحاق الحضرمي، وأبي نعيم، وعفان، والقعنبي، وأبي الوليد الطيالسي، وابن أبي شيبة... وغيرهم.
وحدث عنه: النسائي في "سننه"، وموسى بن هارون، ويحيى بن صاعد، وعلي بن أبي طاهر القزويني، وعمر بن محمد بن عيسى الجوهري، وأحمد بن محمد بن شاكر الزنجاني، وغيرهم.
ونجد أن رواية الأثرم لمسائل الإمام أحمد بن حنبل من أَجلِّ الروايات عن الإمام أحمد، لا سيما وقد أكثر من الرواية عنه، مع ضبطه، ودقة نقله. إلى جانب موافقة غالب روايات الأثرم للمذهب، وذلك دليل على معرفته بآخر القولين الذين استقر عليهم الإمام أحمد بن حنبل في كل مسألة فقهية بعد التحقق والتوثيق، إلى جانب جودتها وحسنها ودقتها في ترتيبها حيث أصبحت مضرب المثل لغيرها من المسائل من حسن التصنيف والترتيب حتى قال الشيخ "يحيى الصرصري" في لاميته التي ذكر فيها الإمام أحمد وأصحابه:
وبالأثرمِ امتازتْ مسائلُ أحمدَ *** لناشدِها المستنبطِ المتأمّلِ
ونجد أن تلك المسائل كَثُرَ النقل منها واعتنى بها فقهاء المذاهب الأخرى كابن عبد البر في "التمهيد" و"الاستذكار" الذي نقلها بالإسناد المتصل، وكذلك ابن المنذر في "الأوسط"، وابن حجر في "فتح الباري"، وهذا دليل على فقه الراوي، وحرص ابن الأثرم على الاقتداء بالإمام أحمد رحمه الله والأخذ عنه وانتحال مذهبه.
قال أبو بكر الخلال: «كان الأثرم جليل القدر، حافظًا، وكان عاصم بن علي لما قدم بغداد، طلب رجلًا يخرج له فوائد يمليها، فلم يجد في ذلك الوقت غير أبي بكر الأثرم. فكأنه لما رآه لم يقع منه موقعًا لحداثة سنه. فقال له أبو بكر: أخرج كتبك، فجعل يقول له: هذا الحديث خطأ وهذا غلط، وهذا كذا. قال: فسر عاصم بن علي به، وأملى قريبًا من خمسين مجلسًا. وكان يعرف الحديث ويحفظ. فلما صحب أحمد بن حنبل ترك ذلك، وأقبل على مذهب أحمد».
وعن أَبَي بكرٍ المَرُّوْذِيَّ قال: قَالَ الأَثْرَمُ: "كُنْتُ أَحْفَظُ - يَعْنِي: الفِقْه وَالاخْتِلاَف - فَلَمَّا صَحِبْت أَحْمَد بن حَنْبَلٍ تركتُ ذَلِكَ كُلَّهُ".
قال إبراهيم الأصبهاني: أبو بكر الأثرم أحفظ من أبي زرعة الرازي وأتقن.
وقال ابن حبان البستي: «كان من خيار عباد الله، من أصحاب أحمد بن حنبل، ممن روى عنه المسائل».
وكان ذا دُرية واسعة في الحفظ والإتقان ومعرفة الحديث، حتى قال عنه يحيى بن معين: «كان أحد أبوي الأثرم جنيًا» لسرعة فهمه وحفظه.
*ومن مصنفاته*:
1- «السنن» في الفقه على مذهب أحمد وشواهده من الحديث.
2- «علل الحديث ومسائل أحمد بن حنبل»، أو: «العلل ومعرفة الرجال».
3- «ناسخ الحديث ومنسوخه».
4- كتاب «السنة»: ذكره الكتاني في "الرسالة المستطرفة" وربما كان جزء من كتابه الأكبر "السنن".
5- كتاب «التاريخ»: ذكره ابن النديم في "الفهرست" ولعله عنوان آخر لكتاب "العلل".
وقد اختلفوا في تحديد وفاة الإمام أبي بكر الأثرم اختلافًا كبيرًا فقال الذهبي: " لَمْ أَظفر بِوَفَاةِ الأَثْرَم، وَمَاتَ بِمَدِيْنَةِ إِسْكَاف فِي حُدُوْدِ السِّتِّيْنَ وَمائَتَيْنِ قبلهَا أَوْ بَعْدهَا
وقال أيضًا: "أظنه مات بعد الستين ومئتين"، وترجم له في "العبر" في وفيات سنة إحدى وستين ومئتين رحمه الله تعالى.
الألوكة
✍ أسعد الله أوقاتكم بطاعته
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
03 Apr 2023 10:27
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 12 )
#الامام_المعلمي
صدر حديثًا كتاب "الإمام عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، حياته وآثاره"، تصنيف "أحمد بن غانم الأسدي"، وذلك عن دار طيبة الخضراء.
ويحوى هذا السفر ترجمة نفيسة للعلامة المعلمي رحمه الله، مع حصر لجميع كتبه وتحقيقاته وآثاره العلمية ومراسلاته الخطية.
والإمام عبدالرحمن بن يحيى المعلمي من العلماء المحققين الذين كانت لهم جهود ملموسة في الدفاع عن السنة والزود عنها ضد أهل البدع، ينسب إلى بني المعلم من بلاد عتمة باليمن، ولد في أول سنة (1313هـ) بقرية (المحاقرة) باليمن، نشأ في بيئة متدينة صالحة، وقد كفله والداه وكانا من خيار تلك البيئة.
واشتغل منذ بواكير طفولته بطلب العلم فأخذ العلم عن بعض العلماء في اليمن، وذاكرهم في الفقه والنحو والفرائض وغيرها، وقبل ذلك درَسَ القرآن على والده.
ومن هؤلاء العلماء:
1- والده "يحيى"، حيث قرأ عليه القرآن.
2- الشيخ "أحمد بن مصلح الريمي"، حيث تذاكر معه بعض كتب النحو.
3- والشيخ "أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي"، حيث قرأ عليه الفقه والفرائض والنحو.
4- والشيخ "سالم بن عبد الرحمن باصهي" ذكره الشيخ في رسالة له في الرد على القائلين بوحدة الوجود، ألفها الشيخ عام 1341هـ.
وارتحل إلى جيزان سنة 1336هـ فولاه محمد الإدريسي- أمير عسير حينذاك - رئاسة القضاء، وكان إلى جانب القضاء يشتغل بالتدريس، فلما توفي محمد الإدريسي سنة 1341هـ ارتحل إلى الهند وعين في دائرة المعارف قرابة الثلاثين عامًا، ثم سافر إلى مكة عام 1371هـ، فعُيِّن أمينًا لمكتبة الحرم المكي في شهر ربيع الأول من نفس العام.
وعرف بالمصنفات البديعة التي ينصر فيها مذهب أهل السنة منها: كتابه "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"، و"الأنوار الكاشفة" في الرد على كتاب (أضواء على السنة) لمحمود أبي رية، و"محاضرة في كتب الرجال"، وكتاب "العبادة" مجلد كبير، وكتاب "حقيقة التأويل والرد على المتصوفة القائلين بوحدة الوجود"، وكتاب "الحكم المشروع في الطلاق المجموع"، وحقق كثيرًا من كتب الأمهات، منها أربع مجلدات من كتاب "الإكمال" لابن ماكولا، وأربع مجلدات من "الأنساب" للسمعاني، وكتاب "الرد على الإخنائي" لشيخ الإسلام، وقد توفي رحمه الله تعالى صبيحة الخميس السادس من شهر صفر عام 1386 عن ثلاثة وسبعين سنة بعدما أدى صلاة الفجر في الحرم وعاد إلى مكتبة الحرم.
وقد أثنى عليه عدد كبير من معاصريه من أهل العلم والفضل، ووصفه غير واحد منهم بالعلامة المحقق، ومن هؤلاء العلماء المثنين عليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووصفه بالعالم خادم الأحاديث النبوية، وكذا أثنى عليه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد الفقي والألباني وقال عنه الشيخ بكر أبو زيد: ذهبي عصره العلامة المحقق.
وتعد هذه الترجمة من أوسع الترجمات وأكثرها تعلقًا بالسيرة الذاتية للشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، وقد قسم الكاتب فصول ترجمته في عدة مباحث فرعية استوفت كل ما يتعلق بالنتاج العلمي للعلامة المعلمي، وكشفت اللثام عن جوانب مخفية من الرحلة الحياتية للمصنف رحمه الله.
الألوكة
✍ أسعد الله أوقاتكم بطاعته
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
01 Apr 2023 11:48
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 10 )
#ستيتة_المحاملي
في منتصف القرن العاشر الميلادي وقت كانت أوربا غارقة في الجهل والخرافات كان لا يوجد سوى مكان واحد يجب أن تذهب إليه: هو بغداد، بيت الحكمة.
وفي بغداد توجد ستيتة المحاملي (ت 987)، التي اشتهرت بعقلها القانوني، إضافةً إلى إتقانها الرياضيات، وهي امرأة عبقرية احتُفل بثقافتها على نطاق واسع، وأثنى على قدراتها ثلاثة من أعظم مؤرخي حقبتها.
هي أمة الواحد بنت القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد بن أبان المَحَامِلِي الضبي، وُلِدت في بغداد في بدايات القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)، وتُنسب إلى أسرة المَحامِلي، وهي أسرةٌ اشتهرت بتفوُّقها العلمي، وتألَّقت وعلا شأنها، وذاع صيتها، وسجل التاريخ أخبارها وسيرتها ومسيرتها في رحلة التعليم الطويلة؛ إذ نعرف كثيرًا عن والدها وابنها وحفيدها، الذين كانوا يُعدُّون قضاة وعلماء جيدين، وذلك أكثر مما نعرف عنها.
درست هذه العائلة الأدب العربي والفقه والتفسير والرياضيات مدة مئتي عام، إذ نعلم أنه كانت تُستشار على نطاق واسع نظرًا لمعرفتها القانونية والرياضية، وأنها حلت مشكلات الميراث التي تنطوي على معرفة متقدمة في الحقل الجديد لذلك العصر: الجبر.
ويصفها خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام: «فاضلة وعالمة بالفقه والفرائض (علم المواريث) وحاسبة من أهل بغداد، كانت من أحفظ الناس للفقه.. وكانت تُفتي، وحدثت وكُتِب عنها الحديث.
ويقول عنها «الذهبي» في كتابه سير أعلام النبلاء: «حفظت القرآن والفقه للشافعي، وأتقنت الفرائض، ومسائل الدور والعربية، وغير ذلك».
أما سليم الحسني، رئيسُ مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة، المشرف على إعداد كتاب «اكتشف التراث الإسلامي في عالمنا - ألف اختراع واختراع»،يقول: إن مؤسسة العلوم والحضارة عثرت حديثًا -على سبيل المثال- على بحوث في مركز التراث في بغداد عن عالمة بغدادية من العصر العباسي؛ تُدعى «سُتيتة» البغدادية، وقد كانت متخصصة في علوم الرياضيات.
ويوضح الحسني أنَّ الرياضيات أدّت في ذلك الوقت خدمة اجتماعية، ويعطي مثالًا: اعتاد الناس حين بناء منازلهم على إعطاء ما يشبه المقاولة للعمال، فإذا -لسبب ما- بُني نصف المنزل فقط -مثلًا- يتوجهون بشكواهم للقاضي من أجل أخذ حقوقهم. لكن كيف سيحسب القاضي ذلك؟
يجيب الحسني: يذهبون إلى خبراء حساب، مثل سُتيتة التي تستخدم عمليات رياضية وجبر معقدة لقياس حجم البناء، وسطح الأرض وكمية الحجر وساعات العمل...إلخ؛ أي تُجري معادلات رياضية، وتطلع بنتيجة تعرضها على القاضي، وبذا تكون ما نسميه في العصر الحديث «شاهدًا أو خبيرًا علميًّا» expert witness.
وكانت مسائل الميراث وكيفية توزيع عائدات الملكية على نحو صحيح بين الناس من مختلف علاقات القرابة مع المتوفى هي أعشاش الدبابير، وخاصة في الرياضيات، حتى وقعت تحت نظر العقلية الفذة لمحمد الخوارزمي ، الرجل الذي جمع بين أساليب حل المشكلات الجبرية اليونانية وإثبات الشكليات الديوفانتية مع نظام عددي عشري من العلماء الهنود، لخلق ما نعرف أنه سلف الجبر الحديث. (اسم الجبر في الواقع هو مصطلح صاغه الخوارزمي ويعني عملية إحلال الرموز محل الأعداد المجهولة أو المعلومة). وفي أعماله طبق تقنياته على أنظمة المعادلات المعقدة، التي تَنتج عندما تحاول حساب شبكة من المطالب المتنافسة على التركة.
وقد قدمت «ستيتة» إسهامات أصيلة في هذا المجال، كما هي الحال فيما يخص نظرية الحساب أيضًا، التي تأتي في واقع الأمر بفضل اعتماد نظام عددي لم يكن معاديًا بشدة للحساب.
وعلى الرغم من أنك لن تتمكن من العثور على مصادر تفصّل أنواع الحلول الدقيقة التي أسهمت بها في الرياضيات فإننا نعرف أن علماء الرياضيات في وقت لاحق أشاروا إلى عملها، ومن ثم يجب علينا إجراء مقارنة بين علماء الرياضيات في وقتها للحصول على تقدير لِما كانت عليه؛ إذ عاشت بعد مئة عام من الخوارزمي وبعد زمن أبي كامل الحاسب (850-930)، عملاقَي الرياضيات العربية الكلاسيكية. وكان كل منهما مهتمًّا بتصنيف حلول لأنظمة كاملة من المعادلات، مثل تقسيم الخوارزمي لجميع المعادلات التربيعية إلى ست فئات قابلة للحل (أو كما كان يعتقد)، أو حلول أبي كامل للمسائل المنطوية على كميات غير حقيقية.
وقد ذكرت في سيرة حياتها أنها لم تكن معروفة لحل المسائل الفردية وحسب، بل في إنشاء حلول عامة لأنواع من المسائل أيضًا، التي يجب أن تكون امتدادًا منطقيًّا لعمل الخوارزمي وأبي كامل، ولما كان عملها يتابع جيدًا ويحصل على التقدير الكافي لدرجة ذكره من قبل مصادر لاحقة؛ فمن العدل أن نقول إنها حققت مستوى ملحوظًا من التطور في الجبر.
المصادر:
الأعلام للزركلي.
سير أعلام النبلاء للذهبي.
© الباحثون السوريون
✍ أسعد الله أوقاتكم بطاعته
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
30 Mar 2023 11:11
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 8 )
#أبو بكر_الأصبهاني
هو: محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب بن يزيد أبو بكر الأصبهاني، الأسدي شيخ القراء في زمانه.
ذكره الذهبي ضمن علماء الطبقة السابعة من حفاظ القرآن.
كما ذكره ابن الجزري ضمن علماء القراءات.
وقد تلقى أبو بكر الأصبهاني القراءة عن خيرة علماء عصره وفي مقدمتهم: أبو الربيع سليمان بن أخي الرشديني.
قال عبد الواحد بن أبي هاشم: حدثنا محمد بن أحمد الدقاق، حدثنا محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني قال: قرأت القرآن على أبي الربيع بن أخي الرشديني وختمت عليه إحدى وثلاثين ختمة، وقلت له: الى من تسند قراءتك؟ قال: الى ورش
كما قرأ الأصبهاني على مواس بن سهل والحسن بن الجنيد، والفضل ابن يعقوب الحمراوي بمصر. وقال الأصبهاني دخلت مصر ومعي ثمانون ألفا فأنفقتها على ثمانين ختمة اهـ
وقد اشتهر الأصبهاني بالقراءة وعظم شأنه مما استوجب الثناء عليه، وفي هذا المعنى يقول أبو عمرو الداني :
الأصبهاني إمام عصره في رواية ورش لم ينازعه في ذلك أحد من نظرائه
ولا زالت قراءة الأصبهاني عن ورش يتلقاها المسلمون بالقبول حتى الآن.
كما حدث الأصبهاني عن عثمان بن أبي شيبة، وداود بن رشيد، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وعبد الله بن عمر مشكدانه وغيرهم
توفي الأصبهاني ببغداد سنة ست وتسعين ومائتين من الهجرة. ت 296 هـ/ 908م
رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله أفضل الجزاء.
واختار له ابن الجزري سِتًّا وَعِشْرِينَ طَرِيقًا
موقع ن للقرآن وعلومه
✍ أسعد الله أوقاتكم بطاعته
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
28 Mar 2023 07:22
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 6 )
#أسد_بن_الفرات
هو أبو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان قاضي القيروان، تلميذ مالك بن أنس رحمه الله .
نيسابوري الأصل ولد بحران سنة 142 هـ .
رحل به والده وعمره عامان ، لمدينة القيروان سنة فانقطع لقراءة القرآن وعلومه .
كان أسد يقول : أنا أسد ، وهو خير الوحوش ، وأبي فرات وهو خير المياه ، وجدي سنان وهو خير السلاح .
قال سليمان بن خالد: لما سمع أسد الموطأ عن مالك قال له: زدني سماعاً. قال حسبك ما للناس. وكان مالك إذا تكلم بمسألة كتبها أصحابه فرأى أسد أمراً يطول فرحل إلى العراق .
قال أسد : لما أتيت الكوفة ، أتيت أبا يوسف القاضي ، فوجدته جالساً ومعه شاب وهو يملي عليه مسألة. فلما فرغ منها قال ليت شعري ما يقول فيها مالك ؟ قلت : كذا وكذا. فنظر إليّ ! فلما كان في اليوم الثاني كان مثل ذلك ، وفي الثالث مثله فلما افترق الناس دعاني .
وقال : من أين أنت ومن أين أقبلت ؟ قال فأخبرته .
قال : وما تطلب ؟
قلت : ما ينفعني الله به ، فعطف عليّ الشاب الجالس ، فقال : ضمه إليك ، لعل الله ينفعك به في الدنيا والآخرة فخرجت معه إلى داره ، فإذا هو محمد بن الحسن الشيباني . فلزمته حتى كنت من المناظرين من أصحابه .
قال أسد رحمه الله : فبينما نحن مع محمد بن الحسن يوماً في الحلقة إذ أتاه رجل يتخطى الناس حتى سارَّ محمد بن الحسن الشيباني فسمعنا محمد يقول : (إنا لله وإنا إليه راجعون) مصيبة ما أعظمها مات مالك بن أنس . مات أمير المؤمنين في الحديث قال : ثم فشا الخبر في المسجد وماج الناس حزناً لموت مالك بن أنس .
قال أسد : فوالله ما بالعراق حلقة إلا وذكر مالك فيها.
فندم أسد على ما فاته وجمع أمره على الانتقال إلى مذهبه . وقال أسد عند ذلك : إن كان فاتني لزوم مالك فلا يفوتني لزوم أصحابه . فقرر الرحيل إلى مصر .
قال أبو اسحاق الشيرازي: لما قدم أسد مصر أتى إلى ابن وهب وقال هذه كتب أبي حنيفة ، وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك. فتورع ابن وهب وأبى.
فذهب إلى ابن القاسم فأجابه إلى ما طلب.
ومعه دون اسد ستين كتاباً تشمل أسئلة اهل العراق وقياسها علي مذهب مالك ، وتسمى تلك الكتب الأسدية .
قال ابن سحنون: وحصلت لأسد بتلك الكتب في القيروان رياسة.
ومنعها أسد من سحنون ، فتلطف سحنون حتى وصلت إليه . ثم ارتحل سحنون بالأسدية إلى ابن القاسم . فقال لسحنون : فيها شيء لا بد من تغييره ، وأجاب عما كان يشك فيه ، واستدرك فيها أشياء كثيرة ، ونظر سحنون فيها نظراً آخر فهذبها ، وبوّبها ودونّها ، وألحق فيها من خلاف كبار أصحاب مالك ما أختار ذكره، وذيّل أبوابها بالحديث والآثار ، إلا كتباً منها مفرقة ، بقيت على اصل اختلاطها في السماع ، فهذه هي كتب سحنون المدونة والمختلطة. وهي أصل المذهب المرجح روايتها على غيرها ، عند المغاربة ، ونُسِيَتْ الأسدية فلا ذكر لها الآن.
قال أبو العرب: كان أسد ثقة ، لم يرم ببدعة .
قال سلمان بن عمران: سمع أسد بن هشيم اثني عشر ألف حديث. وقال: سمعت من أبي زائدة عشرين ألف حديث.
وقال ربما رأيت أسداً يدق صدره ويقول: واحسرتا إن مت ليدخلن القبر مني علم عظيم. قال: وبسبب أسد ظهر العلم بإفريقية.
قال عمران بن أبي محرز: جاءنا موت أسد فاستعظمه أبي ، وقال: اليوم مات العلم.
ولي الأمير زيادة الله أسداً القضاء شريكاً لأبي محرز الكناني، سنة ثلاث أو أربع ومائتين. فاشتركا في القضاء. فكان أسد أغزرهما علماً وفقهاً ، وأبو محرز أسدهما رأياً، وأكثرهما صواباً .
كان أسد بن الفرات رحمه الله مع علمه وفقهه أحد الأبطال الشجعان ، خرج سنة اثنتي عشرة والياً على جيش صقلية ، في عشرة آلاف رجل ، منهم تسعمائة فارس . وكان سبب غزوة صقلية أنهم كانوا معه في هدنة ، وكان في شرطهم أن من دخل إليهم من المسلمين وأراد أن يرد بعضهم رده ، فرجع إلى زيادة الله (الوالي) أن عندهم أسرى ، فلما جاء رسل طاغيتها ، جمع زيادة الله العلماء وسألهم عن الأمر :
فقال أبو محرز: يستأنى -ننتظر- حتى يتبين.
وقال أسد: يسأل رسلهم عن ذلك ..!
فقال أبو محرز: كيف يقبل قولهم عليهم ..!
فقال أسد : بالرسل هادناهم وبهم نجعلهم ناقضين . قال الله تعالى : ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلّم وأنت الأعلون ). فنحن الأعلون . فسأل الرسل ، فاعترفوا أنهم في دينهم لا يحلُّ لهم ردهم . فأمر زيادة الله بالغزو إليها وتنصيب أسد بن الفرات على أمرة الجيش .
فخرج إلى صقلية وظفر بكثير منها.
وكانت وفاة أسد في حصار سرقوسة ، من غزوة صقلية ، وهو أمير الجيش وقاضيه . سنة ثلاث عشر ومائتين. وقيل أربع عشرة، وقيل سبع عشرة. وقبره ومسجده بصقلية.
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للإمام القاضي عياض الأندلسي المالكي
رابطة العلماء السوريين
✍ أسعد الله أوقاتكم بطاعته
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
26 Mar 2023 13:16
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 5 )
#ابن_قاضي_الجبل
أحمد بن الحسن بن عبد اللّه بن محمد ابن قُدامة، الفقيه الحنبلي، المحدّث، شرف الدين أبو العباس المقدسي الاَصل، الدمشقي، المشهور بابن قاضي الجبل.
كتب بخطه قال: ولدت في الساعة الأولى من يوم الاثنين تاسع شعبان سنة ثلاث وتسعين وست مئة.
خلف ثروة ومالا جما، وكتبا وأملاكا وغيرها.
وكانت فيه دعابة، ومزح، ونكات في البحث" أو "وإنكات".
له كتاب في (أصول الفقه) لم يكمل
وصل فيه إلى أوائل القياس ولم يعاود النظر حتى اخترمته المنية قاله المرداوي
قال ابن مفلح: وله اختيارات في المذهب
قال عنها ابن عثيمين في الشرح الممتع:"جيد جدا".
ومن كتبه (المناقلة بالأوقاف) مطبوع
و " الرد على إلكيا الهراسي " مجلدين لم يتم وكتاب الهراسي هو مفردات أحمد ، و " قطر الغمام في شرح أحاديث الأحكام " هو شرح المنتقى لم يتم ، و " تنقيح الأبحاث في رفع التيمم للأحداث " و"القصد المفيد في حكم التوكيد" ، "ومسألة رفع اليدين" ، "والكلام على قوله تعالى " أأنت قلت للناس اتخذوني ".
والفائق مجلد كبير
وآراؤه الأصولية يمكن جمعها من كتاب التحبير وشرح الكوكب
ومن أشهر تلامذته الزين ابن رجب وبدر الدين الزركشي
ومن شعره قوله:
نبيي أحمد وكذا إمامي وشيخي أحمد كالبحر طامي
واسمي أحمد وبذاك أرجو شفاعة اشرف الرسل الكرام
الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا
فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام
قال ابن مفلح: قال مرة لعمي الشيخ برهان الدين: كم تقول احفظ بيت شعر؟ قال: فقلت: عشرة آلاف. فقال: بل وضعفها.
كان من أهل البراعة والفهم، متقنا عالما بالحديث وعلله، والنحو واللغة، والأصلين والمنطق، وكان له في الفروع القدم العالي.
سمع من القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة، وعيسى المطعّم، ويحيى بن سعد، وغيرهم.
وحدث، وتفقه، وبرع، ودرس، وأفتى، وشغل بالعلم زمانا. وتعين ورأس على أقرانه، ثم مات أقرانه وانفرد.
قال ابن قاضي شهبة: سمع في صغره من إسماعيل الفراء، ومحمد بن الواسطي، وعيسى المغاري، وهذه الطبقة، ثم طلب بنفسه بعد العشر وسبع مئة فسمع من التقي ونحوه، وأجازه طائفة، وخرج له ابن سعد مشيخة حدث بها.
قال ابن مفلح عن هذه المشيخة: خرج له المحدث شمس الدين مشيخة عن ثمانية عشر شيخا حدث بها.
وقال الذهبي: الإمام العلامة، صاحب فنون، وذهن سيال، وتودد. سمع معي من التقي ابن مؤمن، وطلب الحديث وقتا وحدث.
وقال المقريزي: علامة وقته في كثرة النقل وفقه الحنابلة.
أجاز له والده، وأبو الفضل ابن عساكر، والمنجى التنوخي، وابن القواس، وغيرهم.
أفتى في شبيبته، وكان قد درس قديما، وحضر درسه الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأثنى عليه، وأذن له في الإفتاء.
قال ابن تغري بردي: صحب ابن تيمية وسمع منه، وتفقه به وبغيره، وأفتى ودرس، وصنف كتاب (الفائق) في الفقه وغيره.
قال ابن مفلح: قرأ على الشيخ تقي الدين عدة مصنفات في علوم شتى، وذكر _ هو _ لعمي الشيخ برهان الدين: أنه قرأ عليه (المحصل) للرازي.
وطلب في أواخر عمره إلى القاهرة لتدريس مدرسة السلطان حسن، فولي بها مشيخة سعيد السعداء، وأقبل عليه أهل مصر واخذوا عنه، ثم أعيد إلى دمشق في منصب قاضي القضاة الحنابلة بها بصرف جلال الدين يوسف بن محمد بن عبد الله المرداوي، وذلك في رمضان سنة سبع وستين وسبع مئة. قال ابن قاضي شهبة: فباشر مباشرةً لم يحمد فيها؛ ووقع بينه وبين الحنابلة من المراودة وغيرهم امور كثيرة.
قال ابن كثير: وكان من مشايخ العلماء الكبار، وممن يأذن للقضاة في الإفتاء، كثير الفنون. له يد في علوم متعددة، وله مصنفات عديدة قديمة وحديثة.
قال ابن تغري بردي حيث قال: وولي قضاء الحنابلة بدمشق عوضا عن جلال الدين يوسف بن محمد بن عبد الله المرداوي في يوم الثلاثاء ثامن شهر رمضان سنة سبع وستين، وحمدت سيرته، ودام في المنصب إلى أن توفي.
باشر القضاء دون الأربع سنين إلى أن مات وهو قاض.
قال ابن مفلح: وله اختيارات في المذهب، فمنها: أن النزول عن الوظيفة تولية. وهذه مسألة تنازع فيها هو والقاضي برهان الدين الزرعي، وأفتى كل منهما بما اختاره. وله مصنفات منها: ما وجد من (الفائق) وكتاب في (أصول الفقه) لم يكمل كـ(شرح المنتقى).
توفي بمنزله في الصالحية صبيحة يوم الثلاثاء الرابع عشر من رجب، وصلي عليه بعد الظهر بالجامع المظفري، ودفن بتربة جده الشيخ أبي عمر، وشهده جمع كثير.
وقد ذكر له ابن طولون حكايات مطولة تدل على فضله ومكانته. فرحمه الله رحمة واسعة.
المجلس العلمي
✍ أسعد الله أوقاتكم بطاعته
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
24 Mar 2023 13:38
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 2 )
#ابو_الدرداء
أبو الدردادء رضي الله عنه هو: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي. ويقال له: عويمر بن عامر.
وهو حكيم هذه الأمَّة كما في بعض المراسيل وأقوال السَّلف. قال رضيَ الله عنه: "كنتُ تاجرًا قبل أن يُبْعَث النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فلما بُعِثَ محمَّدٌ؛ زاولتُ التجارة والعبادة؛ فلم تجتمعا؛ فأخذتُ العبادة وتركتُ التجارة". فهو رضيَ الله عنه لما رأى أن التجارة تزاحم العبادة، ورأى من نفسه عدم القدرة على جمعهما؛ أقبل على الأفضل.
ومنَ الناس مَنْ يستطيع الجَمْع بينهما، كما كان أبو بكر رضيَ الله عنه تاجرًا عابدًا عالمًا، وكذلك عبدالرحمن بن عوف رضيَ الله عنه.
قال الذهبي رحمه الله في ترجمته: الإمام القدوة، قاضي دمشق.. حكيم هذه الأمة.. وسيد القراء بدمشق.
وقد حضر بدر، ثم شهد أحدا وأبلى فيه بلاء حسنا.
ومن حِكَمه في المال والغنى قوله: "أهل الأموال يأكلون ونأكل، ويشربون ونشرب، ويلبسون ونلبس، ويركبون ونركب، ولهم فضولُ أموالٍ ينظرون إليها وننظر إليها معهم، وحسابها عليهم، ونحنٌ منها برآء".
لقد كان رضيَ الله عنه موصوفًا بالعقل والحكمة، حتى إن ابن عمر رضيَ الله عنهما يقول: "حدِّثونا عن العاقلَيْن؛ معاذٍ وأبي الدَّرْداء".
سُئلت أمُّ الدَّرْداء: "أيُّ عبادةِ أبي الدَّرْداء كانت أكثر؟ قالت: التفكُّر والاعتبار". وكيف لا يكون دائم التفكر وهو القائل: "تفكُّر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة"
ومن حكمته رضيَ الله عنه ما رواه أبو قِلابة: "أنَّ أبا الدَّرْداء مرَّ على رجل قد أصاب ذنبًا، وكانوا يسبُّونه؛ فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قَلِيبٍ؛ ألم تكونوا مُسْتَخْرِجِيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبُّوا أخاكم، واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا نُبْغِضُه؟ قال: إنما أبْغَضُ عمله، فإذا تركه فهو أخي".
وكان من الصحابة الذين جمعوا القرآن كله، فعن أنس رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. رواه البخاري.
واشتهر بالعبادة، فكان يصوم النهار ويقوم الليل، حتى قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن لجسدك عليك حقاً، ولربك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، صم وأفطر، وصل، وائت أهلك، وأعط كل ذي حق حقه. رواه البخاري.
كان يدعو لأصحابه كثيرًا؛ قالت أمُّ الدَّرْداء: "كان لأبي الدَّرْداء ستون وثلاثمائة خليلٍ في الله، يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك؛ فقال: إنه ليس رجلٌ يدعو لأخيه في الغيب، إلاَّ وَكَّلَ الله به مَلَكَيْن يقولان: ولك بمثل، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟!".
ولا زالتِ الحِكْمة على لسانه حتى في حال مرضه؛ فقد اشتكى مرَّةً؛ فدخل عليه أصحابه فقالوا: "يا أبا الدَّرْداء، ما تشتكي؟ قال: اشتكي ذنوبي. قالوا: فما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة. قالوا: أفلا ندعوا لك طبيبًا؟ قال: هو الذي أضجعني".
وكان رضي الله عنه فقيها عالما حكيما، ومن مواقفه وكلماته رضي الله عنه:
1- لما فتحت قبرص مر بالسبي على أبي الدرداء، فبكى، فقيل له: تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: بينما هذه الأمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا الله فلقوا ما ترى، ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه.
2- ومن كلامه: ما لي أرى علماءكم يذهبون، وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا، فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر.
3- وقال: اعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم، واعلم أن قليلاً يغنيك خير من كثير يلهيك، وأن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى.
4- وقال: من أكثر ذكر الموت قلَّ فرحه، وقل حسده.
وقد توفي رضي الله عنه سنة 32 هـ،
قبل استشهاد عثمان رضيَ الله عنه وتوفِّي ومعه شهادة بالإيمان من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقد قال للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم يومًا: بلغني أنَّك تقول إن ناسًا من أمتي سيكفرون بعد إيمانهم. قال: ((أجل يا أبا الدَّرْداء، ولستَ منهم))؛ أخرجه الطِّبرانيُّ
إسلام ويب / الألوكة
✍ أسعد الله أوقاتكم بطاعته
Читать полностью…
بِِصٌمَةّ خَيِّر
23 Mar 2023 10:07
#سلسلة_اهل_العلم_الجزء_الخامس
الحلقة ( 1 )
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه
كنيته: أبو محمد، وأمه: هي ريطة بنت الحجاج السهمية؛ (أسد الغابة؛ لابن الأثير، ).
أسلم قبل أبيه، وهاجر إلى المدينة؛ (صفة الصفوة؛ لابن الجوزي).
روى عبدالله بن عمرو سبعمائة حديث، اتفق له الشيخان على سبعة أحاديث، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بعشرين، وحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علمًا جمًّا، وله مقام راسخ في العلم والعمل؛ (سير أعلام النبلاء).
روى البخاري عن أبي هريرة قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثًا عنه مني، إلا ما كان من عبدالله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب؛ (البخاري).
روى أبو داود عن عبدالله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشرٌ يتكلَّم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه، فقال: ((اكتب؛ فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق)) (صحيح أبي داود؛ للألباني).
روى الشيخان عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر، وأقرأ القرآن كل ليلة، قال: فإمَّا ذُكِرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإمَّا أرسل إليَّ فأتيتُه، فقال لي: ((ألم أُخبر أنك تصوم الدهر، وتقرأ القرآن كل ليلة؟))، فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير، قال: ((فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام))، قلت: يا نبي الله، إني أُطيق أفضل من ذلك، قال: ((فإن لزوجك عليك حقًّا، ولزَوْرِكَ عليك حقًّا، ولجسدك عليك حقًّا))، قال: ((فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعْبَدَ الناس))، قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: ((كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا)) قال: ((واقرأ القرآن في كل شهر))، قال قلت: يا نبي الله، إني أُطيق أفضل من ذلك، قال: ((فاقرأه في كل عشرين))، قال قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: ((فاقرأه في كل عشر))، قال قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: ((فاقرأه في كل سبع، ولا تزد على ذلك؛ فإن لزوجك عليك حقًّا، ولزورك عليك حقًّا، ولجسدك عليك حقًّا))، قال: فشدَّدْتُ فشدَّدَ عليَّ، قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنك لا تدري، لعلك يطول بك عمر))، قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبِرت وَدِدْتُ أني كنت قبلت رخصةَ نبي الله صلى الله عليه وسلم؛ (البخاري/مسلم ).
قال يعلى بن عطاء بن أبي رباح: كان عبدالله بن عمرو يكثر من البكاء، ويغلق عليه بابه، ويبكي حتى رمصت عيناه (ما يجتمع في زوايا الأجفان من رطوبة العين)؛ (حلية الأولياء؛ لأبي نعيم الأصفهاني).
قال سليمان بن ربيعة حدَّثه أنه حجَّ في إمرة معاوية ومعه المنتصر بن الحارث الضبي في عصابة من قرَّاء أهل البصرة، فقالوا: والله، لا نرجع حتى نلقى رجلًا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مرضيًّا يُحدِّثنا بحديث، فلم نزل نسأل حتى حُدِّثنا أن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه نازِلٌ في أسفل مكة، فعمدنا إليه، فإذا نحن بثقل عظيم يرتحلون ثلاثمائة راحلة منها مائة راحلة ومائتا زاملة (البعير القوي)، قلنا: لمن هذا الثقل؟ فقالوا: لعبدالله بن عمرو، فقلنا: أكل هذا له؟ وكنا نحدث أنه من أشد الناس تواضُعًا، فقالوا: أما هذه المائة راحلة فلإخوانه يحملهم عليها، وأما المائتان فلمن نزل عليه من أهل الأمصار له ولأضيافه؛ فعجبنا من ذلك عجبًا شديدًا، فقالوا: لا تعجبوا من هذا، فإن عبدالله بن عمرو رجل غني، وإنه يرى حقًّا عليه أن يكثر من الزاد لمن نزل عليه من الناس، فقلنا: دلونا عليه، فقالوا: إنه في المسجد الحرام، فانطلقنا نطلبه حتى وجدناه في دبر الكعبة جالسًا رجل قصير أرمص بين بردين وعمامة وليس عليه قميص قد علق نعليه في شماله؛ (حلية الأولياء).
من اقواله:
قال عبدالله بن عمرو: لو تعلمون حق العلم لسجدتم حتى تنقصف ظهوركم، ولصرختم حتى تنقطع أصواتكم، فابكوا فإن لم تجدوا البكاء فتباكوا؛ (صفة الصفوة).
وقال: لأن أدمع دمعة من خشية الله عز وجل أحبُّ إليَّ من أن أتصدَّقَ بألف دينار؛ (صفة الصفوة).
قال عبدالله بن عمرو: جلست من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسًا، ما جلست منه مجلسًا قبله ولا بعده، فغبطت نفسي فيه، ما غبطت نفسي في ذلك المجلس؛ (حلية الأولياء).
قال عبدالله بن عمرو بن العاص: كان يقال: دع ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن ورقك؛ (حلية الأولياء).
توفي عبدالله بن عمرو بن العاص سنة خمس وستين، وهو يومئذٍ ابن اثنتين وسبعين سنة؛ (الطبقات الكبرى، لابن سعد).
الألوكة
✍ أسعد الله أوقاتكم بطاعته
Читать полностью…
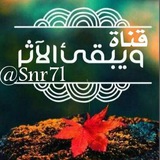
 963
963